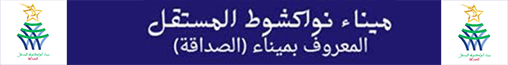ملاحظة: هذا النص عبارة عن محاضرة مشارك بها في الندوة الخاصة بتخليد مئوية الزعيم محمد ولد الخليل الرگيبي المنظمة بنواكشوط يوم 11 نوفمبر 2025).
حين نتحدث عن تاريخ موريتانيا عموما وتاريخ الساحل وأهله بشكل خاص، فإننا لا نستدعي مجرد وقائعٍ جامدةٍ في بطون الكتب، بل نستحضر قامات الرجال الذين نسجوا بتصرفاتهم خيوط الكرامة والسيادة والحكمة. ومن بين أولئك الذين خلّدوا أسماءهم في ذاكرة الرمال والرياح، يسطع اسم الزعيم محمد ولد الخليل، شيخ ارگيبات الساحل، وزعيم فخذ أولاد موسى، وأحد أعمدة الزعامات المحلية في مطلع القرن العشرين. ذلك الزمن الذي كانت فيه البلاد، كما لاحظت بعض التقارير الفرنسية المبكرة في مجلة لجنة إفريقيا الفرنسية الصادرة سنة 1914 أنه فضاء مفتوح لامتحان الرجال وقياس موازين النفوذ بين المجمتع المحلي والسلطات الاستعمارية(1).
صورة الزعيم محمد ولد الخليل في الكتابات والأرشيف الفرنسيين
لم تكن تلك التقارير مجرد عناوين عابرة في نشرات ومطبوعات الإدارة الاستعمارية، بل كانت -بما حملته من شهادات ومراسلات وتقارير ميدانية- جزءًا من آلة معرفية حاولت فهم خريطة السلطة في الساحل خصوصا وفي موريتانيا عموما، فأثبتت -ربما من حيث لا تريد- أن للفضاء الموريتاني منطقَه الأخلاقيَّ والسياسيَّ الخاصَّ، وأنّ النسق الاجتماعي كان يشتغل على قواعد من الضبط والاعتراف والهيبة.
لقد كان محمد ولد الخليل رجلاً يملك من المهابة ما يجعل الصمت من حوله كلامًا. جمع بين الكرم الموريتاني الأصيل، والحزم الذي لا يعرف التردد، والذكاء السياسي الذي يزن المواقف بميزان الذهب. لم يكن شيخ قبيلةٍ فحسب، بل كان زعيمًا لفضاء كامل يمتد من أقاصي شمال الفضاء البيظاني إلى تخوم إينشيري. وقد وصفت التقارير الفرنسية -وعلى رأسها كتاب بول مارتي قبائل موريتانيا محمد ولد الخليل بأنه كان زعيمًا مؤثّرًا بين ارگيبات الساحل، يتمتع بسلطة معترف بها على عدد كبير من الفروع ويسير ويدبر مجالات رعوية واسعة وقوافل تنقل موسمي، وأنّ الناس كانوا يُصغون لرأيه في قضايا الشأن العام كمسائل السلم والحرب، وأنّ نفوذه يتجاوز حدود المجال الذي يتحرك فيه في الساحل. وهذا الوصف يدلّ على أنّ زعامته لم تكن محدودة بحدود جغرافية ضيقة أو محصورة في فخذ واحد، بل كانت زعامة ذات امتداد واسع في الفضاء الموريتاني، تقوم على موازين الهيبة والاحترام، والقدرة على إدارة العلاقات بين المجموعات.
ويضيف مارتي أنّ هيبة محمد ولد الخليل كانت هيبة مركّبة: أساسها النسب، وتدعّمها الثروة القائمة أساسا على الإبل، ويقوّيها الدهاء السياسي، والقدرة على اختيار اللحظة المناسبة للتقدم أو التراجع. فقد كان، على حدّ وصفه، يجيد التفاوض حين يلزم، والمساومة حين تقتضي الظروف، والتهديد أو الانسحاب الاستراتيجي عندما يكون ذلك أنجع، مما جعله محاورًا تُحسب له الحسابات في ميزان القوى بين القبائل(2).
والحق أن تلك المكانة لم تتأسس على عُدّةٍ عسكريةٍ أو على ريْعٍ ضريبي، بل على شرعيةٍ ناعمةٍ قاعدتها السمعة وموثوقية الكلمة وإمكانيةُ تحويلها -عند الحاجة- إلى قرارٍ ضابطٍ للتماسك الداخلي. لذلك كانت الأعين الاستعمارية، وهي ترصد حركات الزعماء، تُدرِك أن الوزن الأثقل -في الصحراء الشنقيطية- ليس دائمًا عند من يملك الرجال والسلاح، بل عند من يملك حقّ الفصل حين تختلط الأصوات.
وما يرسّخ هذا المقام تلك الرسالة الشهيرة التي بعث بها الشيخ أحمد الهيبة بن الشيخ ماء العينين إلى محمد ولد الخليل سنة 1909، والتي حفظت نسختها الأصلية في الأرشيف القومي لما وراء البحار، وقد خاطبه الشيخ أحمد الهيبة فيها بكثير من التقدير والإجلال والاحترام وهو ما يبين رسوخ سلطته الزمنية. هذه الرسالة وحدها تكفي لتأكيد أن ولد الخليل لم يكن زعيمًا محليًا محدود المجال، بل حلقة موصولة في شبكة تمتد من الساقية الحمراء إلى تيرس وآدرار وإينشيري، تتجاوز الحدود التي رسمتها الخرائط الاستعمارية لاحقًا(3). وهي كذلك شهادة على أن القيادات في الساحل لم تكن تعمل في جزر منعزلة، بل في شبكة مترابطة من البيوتات والتحالفات والمجالس، حيث يُستثمر رأس المال الرمزي -المكانة والكرم والحماية- لصناعة توازنٍ يحفظ الدماء ويصون المصالح.
وفي خضمّ التنافس الداخلي بين فروع الرگيبات مثل أهل آفريط وأهل الباردي وأسرة محمد ولد الخليل نفسه على سبيل المثال لا الحصر، ظلّ محمد ولد الخليل الميزان الذي لا يختلّ. لم يكن يفرض رأيه بالسيف، بل بالهيبة؛ ولم يكن يطلب الطاعة بالخوف، بل بالإقناع. وهذا ما لاحظه الوالي الفرنسي بموريتانيا هنري غادن (Henri Gaden) في تقاريره الميدانية والموثقة في الأرشيف القومي لما وراء البحار والتي تغطي ثلاث سنوات من 1911 إلى 1913، حيث سجّل صورة دقيقة لزعيمٍ يعرف متى يتدخل ومتى يلوذ بالصمت، ويعرف كيف يحول الكلمة إلى أداةٍ لإطفاء النيران قبل أن تستعر ذاكرا أن محمد ولد الخليل رجل يستطيع أن يوقف الحرب بكلمة، ويشعلها بنظرة، لكنه يختار أن يطفئها(4). ومن المهم هنا أن نلاحظ أن هذا النمط من القيادة -قيادة “الإطفاء” لا “الإشعال”- كان مطلوبًا في بيئةٍ يمكن أن تنقلب فيها الشرارةُ سُعارًا إذا غاب صاحب الرأي المرجِّح. ومن ثمّ غدا الصمت موقفًا سياسيًا له وزنه، وغدت النظرة حسابًا دقيقًا للتداعيات قبل أن تقع.
مدينة روفيسك 1914: تفاوض لا خضوع
جاءت لحظة مدينة روفيسك السنغالية سنة 1914، وهي لحظة مفصلية في تاريخ موريتانيا. اجتمع فيها محمد ولد الخليل مع كبار الزعماء: أمير آدرار سيدي أحمد ولد عيّده (توفي صبيحة 19 مارس 1932م)، وأمير الترارزة أحمد سالم بن إبراهيم السالم (توفي 25 مايو 1930م)، والشيخ الجليل الشيخ سيديا بابه بن الشيخ سيديا (توفي يوم الخميس 8 يناير 1924م) وغيرهم، في مجلس الحاكم الفرنسي العام بإفريقيا الغربية الفرنسية (AOF) ويليام بونتي (الذي توفي عائدًا من رحلةٍ علاجية إلى فرنسا قبالة ساحل داكار يوم 12 يونيو 1915). ويفهم مما ورد في مجلة لجنة إفريقيا الفرنسية أن الاجتماع كان لحضور اتفاقية سلام سياسية وهي مكاتبة محمد بن الخليل للإدارة الفرنسية في روفيسك يوم 20 مايو 1914(5).
لكن الحقيقة -كما يُظهر تحليل نصوص جريدة الأخبار الاستعمارية (La Dépêche Coloniale) الصادرة في يونيو 1914- أنّ ما جرى لم يكن خضوعًا، بل تفاوضًا نديًّا، وليس إسكاتا للبندقية ولا رميًا له، بل هدنةً فرضها العقل دون أن يُمليها الضعف(6). لقد دخل ولد الخليل المجلس وهو يدرك أنّ السلام ليس استسلامًا، وأن وضع السلاح -في ميزان السياسة الاجتماعية في موريتانيا عموما والساحل خصوصا- يوازي تثبيت الحق في إعادة النظر إن تغيّرت المعادلات. ولعل ذلك ما جعل المجلس -على ما فيه من بروتوكولات رسمية- أقرب إلى “جلسة توازن” منه إلى “جلسة إذعان”.
من السياسة إلى الصورة: تحول الهيبة إلى تمثيل جمالي
حين زار محمد ولد الخليل سان لويس/ اندر بعد أعوام قليلة، التقت به الفنانة الفرنسية آنا كينكان التي تناولت شخصيات موريتانية في أعمالها (معرض باريس 1923). وقفت أمام وجهه، فرأت فيه -كما في صفحات الشبكة التي تحدثت عن معرضها- ملامح رجلٍ لا تشبه ملامح المدن، بل ملامح الصحراء نفسها. ويقدم لنا رسم محمد ولد الخليل الفني البديع بورتريه مفعماً بالهيبة والوقار، مرسوماً بخطوط فحمية قوية وحساسية عالية في الملامح. تظهر ملامح الوجه بتفاصيل دقيقة تُبرز عمق التجربة الإنسانية للشخص المرسوم؛ الجبهة العريضة، العيون الغائرة ذات النظرة المتأملة، والتجاعيد التي تروي تاريخاً طويلاً من الحكمة والصبر والإقدام والشجاعة.
وتأتي العمامة لتُغطي الرأس وقد انسدلت بخفة حول الكتفين في خطوط انسيابية، متوازنة بين الظل والنور، مما يضفي على الرسم إحساساً بالسكينة والسمو. أما اللحية البيضاء الكثيفة فهي تكمّل ملامح الوجه وتؤكد انطباع الوقار والرصانة. والألوان الأحادية بالأسود والرمادي منحت العمل طابعاً كلاسيكياً، وجعلت التركيز منصبًّا على التعبير الداخلي أكثر من المظاهر الخارجية.
ويبدو أن الفنانة كينكان أرادت أن تنقل، ليس فقط ملامح محمد ولد الخليل، بل أيضاً عمقه النفسي وكرامته؛ فالنظرة هنا حادة وهادئة في آنٍ واحد، كما لو أنها تحمل حكمة الصحراء وذاكرة الأجيال. العمل برمته يجمع بين البساطة والعمق، وبين الصرامة الفنية والرهافة الشعورية، ليُقدّم لنا صورة خالدة لمحمد ولد الخليل تُلامس الروح قبل العين(7). ولم يكن هذا التحول من السياسي إلى الجمالي ترفًا فنّيًا، بل اعترافًا بأن للهيبة الممهورة بالصحراء قابليّةً للتمثيل البصري؛ وجهٌ يتقاطع فيه العمق والسكينة والحذر، وتنعكس عليه فكرة القيادة التي “ترى” قبل أن “تتكلم”.
ثم رحل الزعيم في الثامن من سبتمبر سنة 1925، عند أضاة لمريفگ قرب بالنشاب بمنطقة إينشيري، لكنه رحل كما يرحل الكبار: بصمت مهيب، بعد أن أدى ما عليه. لم يكن موته غيابًا، بل امتدادًا. بقي ذكره يتردّد في المجالس، ويتوارث المجتمع اسمه بوصفه رمزًا للهيبة والرزانة السياسية، كما بقيت صورته منحوتة في الذاكرة الأوروبية كما جسدتها الفنانة كينكان، شاهدةً على رجلٍ لم يحكم بعرشٍ ولا بجندٍ، بل بحضورٍ يشبه حضور الرمل واستمرارية الزمن حين يفرض قانون الصحراء. ومن ينظر اليوم في أرشيف المراسلات والتقارير الفرنسية يلحظ أن اسمه يُستدعى بوصفه مِفتاحًا لفهم “سياسة التوازن” في الساحل؛ تلك السياسة التي تُبنى على صيانة الوجاهة، وتقدير المصالح، وتقديم السلم الأهلي على نصرٍ عابرٍ لا يُحصِّن الجماعة. وهكذا بقي محمد ولد الخليل في الرواية الشفوية والكتابة الاستعمارية معًا، نموذجًا لزعامةٍ تُقاس بقدرتها على إطفاء الفتنة قبل أن تُقاس بقدرتها على خوض المعركة.
الخاتمة
إن الحديث عن محمد ولد الخليل ليس استذكارًا لماضٍ بعيد، بل هو استحضار لنموذج يحتاجه الحاضر. نموذجٌ لزعيمٍ فهم معنى الدولة قبل أن تُبنى مؤسساتها، ووعى روح الوطن قبل أن يُدوَّن في الدساتير. لقد كتب عنه الفرنسيون لأنهم أدركوا فيه ما لا يدركونه إلا نادرًا: زعامة لا تصرخ، بل تُسمع. رحم الله محمد ولد الخليل. كان رجلًا سابقًا لعصره، وأحد الذين أثبتوا أن الكلمة -حين تصدر من صاحبها- قد تكون أمضى من السيف، وأن الزعامة لا تُقاس بالعدد ولا بالسلاح، بل بما يتركه صاحبها من أثرٍ في النفوس والذاكرة. وعلى هذا تُبنى شهادة التاريخ: أنّ الهيبة ليست زينة الوجاهة، بل هي أخلاق القوّة حين تُمارس بميزان العدل والسكينة.
د سيدي أحمد ولد الأمير
 المرابع ميديا – al-maraabimedias موقع "المرابع ميديا" التابع لوكالة المرابع ميديا للإعلام والإتصال
المرابع ميديا – al-maraabimedias موقع "المرابع ميديا" التابع لوكالة المرابع ميديا للإعلام والإتصال